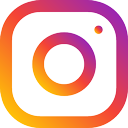|
 |
 |
|
|
لا للاحتلال... لا للأبارتهايد |
الاحتلال الإسرائيلي والأبارتهايد
|
|
تحت رعاية فخامة الدكتور محمود عباس "أبو مازن"
يعقد المؤتمر عبر تقنية "زووم" من خلال الرابط الاتي: https://us02web.zoom.us/j/89890380964 في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني 2022/11/29 حتى 2022/11/30
بالتعاون مع
|
||
المقدمة
الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال الإسرائيلي ومخطط الضم
يحيي العالم في التاسع والعشرين من شهر تشرين الثاني (29/11) من كل عام يوماً عالمياً للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وفي هذه المناسبة بادرت جامعة القدس المفتوحة والحملة الأكاديمية لمناهضة الاحتلال الإسرائيلي والأبارتهايد إلى عقد مؤتمر علمي محكم لتدعيم مفاهيم التحرر الذاتي وإنتاج المعرفة لأنها من أهم العناصر التي تقوم عليها الحياة الإنسانية المعاصرة، في ظل متطلبات مواكبة التطورات المتسارعة، وبات من الغريب أن يعيش شعب أعزل تحت الاحتلال في وقت تنهض الحركات الإنسانية مطالبة بتحرر الإنسان والحيوان وحتى النبات، صوناً للكرامة الإنسانية في القرن الحادي والعشرين الذي تجاهد فيه الإنسانية من أجل تحقيق رفعتها وتطورها بموازاة حفاظها على الكرامة الإنسانية.
تقوم فكرة مؤتمر (التحرر الذاتي للفلسطينيين... إنتاج المعرفة المقاومة) على إبراز مفهوم التحرر الذاتي بوصفه حقاً إنسانياً لشعب يرزح تحت الاحتلال منذ ثلاثة وسبعين عاماً، ومناقشة الطرق والوسائل التي يمكن أن يكون إنتاج المعرفة بضمنها أداة من أدوات التحرر الذاتي.
يوفر المؤتمر فرصاً للباحثين والمهتمين؛ من أجل إثراء معارفهم وتعزيز تجاربهم وخبراتهم وتطوير أدواتهم للوصول إلى أنجع السبل لتحقيق مفهوم إنتاج المعرفة بوصفه مقاومة. والمؤتمر منصة علمية لعرض أساليب مبتكرة وحلول عملية لمواجهة التحديات والصعوبات التي تحول دون تحقيق المقاومة لأهدافها الإنسانية المشروعة.
المدخل المفاهيمي
يهدف المؤتمر إلى إثارة موضوع التحرر المعرفي في حالة فلسطين الخاضعة للشرط الاستيطاني الاستعماري. وتنطلق هذه الورقة المفاهيمية من افتراض أن التحرر المعرفي من مفاهيم الاستعمار و"احتلال العقول"، كما سمّاه فرانز فانون في ستينيات القرن الماضي، وهو أحد أشكال المقاومة المهمة للاستعمار،الذي يضاف لأساليب المقاومة الأخرى: المقاومة السياسية والدبلوماسية، والمقاومة الكفاحية الميدانية، والمقاومة الاقتصادية التنموية، والمقاومة القانونية، والمقاومة الإعلامية. بل إن التحرر المعرفي يقف في المقدمة لإطلاق تلك الأشكال الكفاحية الأخرى، فكيف للمرء أن يكافح ميدانياً واقتصادياً وسياسياً وقانونياً وإعلامياً إذا كان عقله/ها محتلاً؟ فالبداية إذن لكل أمر آخر هي تحرر العقول أولاً من استبطان المفاهيم الاستعمارية، تفكيراً ومناهج بحث، والانفكاك عنها. يدور الحديث هنا عن التحرر من المفاهيم الاستعمارية كأعلوية العرق الأبيض والإنسان الغربي- الصهيوني، وليس عن المفاهيم والقيم الإنسانية التي تجمع عليها البشرية، والتي هي نتاج تراكم المعرفة البشرية. يناهض هذه الأخيرة دعاة ما يطلق عليه اسم "صدام الحضارات" و"الغزو الفكري"، الذين يقسمون العالم إلى فسطاطين لا رابط بينهما سوى حالة الحرب الدائمة.
الإطار النظري
ظهرت مقاربة التحرر المعرفي أولاً في الدراسات ما بعد الاستعمارية Post -Colonial Studies، وتطورت مضامين تعريفه والتوجهات البحثية بشأنه مع تطور هذه الدراسات. ويمكن العودة بداية إلى فرانز فانون في كتابه "بشرة سوداء.. أقنعة بيضاء" الذي صدر أول مرة عام 1952، والذي طرح فيه كيف يستبطن السود اللغة والمفاهيم الاستيطانية الاستعمارية ونعوتها المعرفية ومفاهيمها النمطية (stereotypes) في تعامل بعضهم مع بعض أثناء وبعد زوال الاستعمار العسكري، وكيف تنعكس هذه المفاهيم على الدراسات الأكاديمية التي تستعير الخطاب الاستعماري الغربي في دراسة مجتمعاتها. وفي الفترة نفسها، كتب الباحث من جزر المارتينيك إيمي سيزير، كتابه "الحوار حول الاستعمار Discourse on Colonialism " عام 1950، وحللت هذه الدراسات آثار الاستعمار الراحل على المجتمعات ما بعد الاستعمارية، ولاسيما في المجالات الثقافية والمعرفية والاجتماعية. بشكل عام، تبحث الدراسات ما بعد الاستعمارية في الكيفيات التي يحافظ من خلالها الاستعمار السابق على سيطرته على البلدان المستعمرة بعد رحيل قواته منها والوسائل التي يستخدمها بهذا الاتجاه من إعلام، وأفكار، وتمويل، وتكنولوجيا، وأطروحات تفوق إثني تقوم على سمو الإنسان الغربي المتحضر على الأعراق الأخرى التي ينظر إليها على أنها أقل تطوراً، أو أنها متخلفة (under-developed) قياساً بالدول المتقدمة (Developed Countries).
بعد الدراسات الأولى في حقل الدراسات ما بعد الاستعمارية، تطورت حقول فرعية في جنوب العالم الذي كان خاضعاً للاستعمار، وكذلك من قبل بقايا الشعوب الأصلية والسود والمكسيكيين في الولايات المتحدة التي خضعت لعملية استيطان استعماري أباد الغالبية العظمى من الشعوب الأصلية بدأت منذ قام كريستوفر كولمبوس باكتشافها عام 1492. ففي عام 1957 أطلق الأكاديمي -السياسي الجنوب أفريقي ليوبولد ماركوارد، مصطلح (الاستعمار الداخلي Internal Colonialism) على نظام الأبارتهايد الذي كان قائماً في جنوب أفريقيا آنذاك، مبيناً كيف يقوم هذا النظام على الفصل السياسي والتمييز الاجتماعي والتهميش الاقتصادي والإخضاع المعرفي الثقافي المستند إلى أيديولوجيا عرقية عنصرية. وفي عام 1965 استعمل الباحث الأمريكي اللاتيني بابلو غونزاليس كازانوفا، مصطلح الاستعمار الداخلي لمعالجة حالة التبعية الاقتصادية والتطور اللامتكافئ في دول تلك القارة والمفاهيم النيوليبرالية التي طرحت لترويجها فيها من قبل الدول الاستعمارية السابقة. ولكن الباحث الأمريكي روبرت بلاونر، طرح المفهوم عام 1973 للتعبير عن حالة تقوم فيها الأغلبية الحاكمة في الولايات المتحدة بفرض حالة احتلال ضد الأقلية السوداء داخلها. أما الباحث الأمريكي من أصل مكسيكي رودلفو أكونا، فقد استعاد احتلال أمريكا لمساحات واسعة من المكسيك في القرن التاسع عشر، منها ولايتا تكساس وكاليفورنيا، ونظر في إطار ذلك، في كتابه (أمريكا المحتلة) لعام 1971 إلى المفهوم ذاته على أنه تعبير السيطرة على شعب آخر بعد احتلال أراضيه بالقوة، بحيث يصبح هذا الشعب الآخر في حالة رعايا لا مواطنين خاضعين رغم إرادتهم للحكم الجديد ولسياسات الإبادة العرقية والثقافية، وقد درس أكونا حالة المكسيكيين والمكسيكيات (تشيكانو وتشيكانا) الذين أصبحوا خاضعين للحكم الأمريكي رغماً عنهم/ن بعد احتلال أمريكا لتلك الأجزاء من بلادهم. وقد استعار الباحث الفلسطيني إيليا زريق، مفهوم الاستعمار الداخلي لدراسة حالة فلسطينيي 1948 وذلك في كتاب خاص عام 1979 درس فيه حالة مصادرة أراضيهم وفرض الحكم العسكري عليهم حتى عام 1966، واتباعهم للاقتصاد الإسرائيلي، ومحاولة أسرلة هويتهم.
عوضاً عن دراسات الاستعمار الداخلي، ظهرت دراسات أخرى تحت عنوان النيوكولونيالية منذ أن ابتكر الزعيم الغاني كوامي نكروما هذا المصطلح عام 1965، ليعبر به عن حالة أن الاستعمار قد خرج من الباب، منهياً بذلك احتلاله العسكري، ولكنه عاد من الشباك بوسائل اقتصادية وتكنولوجية وثقافية مهيمنة، وما زال هذا الوصف صالحاً حتى اليوم لحالة الدول التي كانت خاضعة للاستعمار المباشر حتى منتصف القرن الماضي.
وقد شهدت الدراسات ما بعد الاستعمارية نقلة نوعية بعد صدور كتاب إدوارد سعيد عن الاستشراق عام 1978. شرح هذا الكتاب النظرة الغربية للشرق بوصفه الأرض العذراء التي يحن لها الغربيون من جهة، ولكن الذي يتمتع بوضع دوني عن الغرب في الوقت نفسه، لذلك فهو بحاجة للإنسان الغربي ليقوم بتطويره وتحديثه. درس سعيد الأدب والفكر الاستشراقي الغربي وكشف هذه المضامين المعبر عنها فيه. وقد أطلق كتاب سعيد سيلاً من الدراسات ما بعد الاستعمارية التي راحت تدرس الآثار الثقافية للاستعمار على القطاعات المهمشة من الشعوب التي كانت مستعمرة، مثل دراسات المهمشين في الهند ( Subaltern)، لسبيفاك وبهابها وغيرهما، ولاحقاً دراسات الكولونياليتي (Coloniality) التي أطلقها الباحث البيروفي انيبال كويخانو عام 2000، واهتمت هذه الدراسات بمسألة تلازم المعرفة مع القوة، والكيفية التي تنتج بها القوة المعرفة السائدة على حساب المعرفة التي يتم تهميشها وإقصاؤها ، كما اهتم كويخانو بدراسة الطرز الثقافية والاجتماعية التي خلفها الاستعمار في المستعمرات السابقة شاملة السرديات وأشكال الهوية وطرق التعبير عنها، والمفاهيم المعرفية المستعارة من الاستعمار والتي تستخدمها نخب الدول التي خضعت للاستعمار السابق في دراسة مجتمعاتها . ولاحقاً، طور ميجنولو عام 2007 آفاقاً بحثية تعالج كيفية التحرر من الكولونياليتي (De-Coloniality) والانفكاك عنها (De-Linking)، حيث ميز أيضاً بين التحرر من الاستعمار (liberation) والانعتاق (emancipation)، مبيناً كيف أن الأحادية العالمية تركز على فرض الثاني بما هو تحرر للمرأة وتفكيك القيود الاجتماعية ونشر المفاهيم الليبرالية على حساب الأول، فيما تركز التعددية العالمية المنطلقة من جنوب العالم على تلازم العمل على أجندة التحرر وأجندة الانعتاق في آن معاً وبدون تناقض بينهما.
تعود فكرة تلازم المعرفة مع القوة إلى المفكر الفرنسي ميشيل فوكو، الذي رفعها إلى مستوى القاعدة (The rule of immenence)، وتشمل القوة هنا القوة الصلبة والقوة الناعمة سواء بسواء. يرمي الشكل الأول إلى استخدام القوة المباشرة لإحداث تغيير في الواقع يؤدي لإنتاج وعي جديد. أما الشكل الثاني فإنه يستخدم الإعلام وإنتاج الأفكار والعلاقات الاقتصادية وتشويه الهوية والمواطنة وشراء النخب وتطويعها وغيرها لجعل العالم يسير وفق قيم واحدة هي قيم الغرب، معبراً بذلك عن مركزانية غربية (Western- Centrism)، تهدف لفرض رؤاها العالمية الأحادية (Universalism) على العالم بديلاً للرؤية العالمية التعددية (Plura- Versalism) التي تقول بتعدد الثقافات والقيم ومنهجيات المعرفة، مع ما ينشأ عن ذلك من ضرورة تفاعل هذه التعدديات معاً واعتراف كل منها بالأخرى بديلاً عن فرض الأحادية الغربية، كما طرح كويخانو وميجنولو.
في العالم العربي تظهر نتائج الكولونياليتي بوضوح على البحث العلمي، فقد أدت التقسيمات الاستعمارية واتفاقيات سايكس بيكو لعام 1916، إلى تفتيت المنطقة إلى كيانات وطنية بعضها نجح في إنشاء دول ومؤسسات، وبعضها الآخر ما زال يعاني من فشل مزمن في تحقيق ذلك، ونجم عن هذه الترتيبات التي استخدمت القوة الصلبة لأحداثها، أطر معرفية وفكرية تتبنى خطاب التحديث الليبرالي، والاقتصادوية النيوليبرالية، وأفكار الخضوع للغرب والتفكير بتشكيل أطر مؤسسية شرق أوسطية ومتوسطية على حساب التفكير بكيفية تطوير الوحدة العربية، على سبيل المثال. وفتح ذلك المجال للتفكير بمنطق "المصلحة الوطنية" على حساب القيم القومية الجمعية، وبالتالي أصبح ممكناً إقامة وتوثيق العلاقات مع إسرائيل طالما تطلبت "المصلحة الوطنية" ذلك. هذا وقد عززت القوة الناعمة وأفكارها المستخدمة في إطار العلاقات القائمة بين الدول العربية والغرب من هذه التوجهات، حيث تبنت هذه المفاهيم نخب عربية سياسية واقتصادية وفكرية معولمة، تعزز التجزئة القطرية وهوياتها المبعثرة ومصالحها المفتتة والأطر الفكرية النيوليبرالية حول العالم والمنطقة.
أسس تصريح بلفور لعام 1917 رسمياً لنشوء دولة إسرائيل كامتداد غربي في المنطقة، وفرضت القوة الغربية الصلبة تأسيس إسرائيل عام 1948 كامتداد لها في المنطقة، وفرض تلازم القوة والمعرفة الغربي على العرب التعامل مع الصهيونية منذ مؤتمر باريس للسلام عام 1913، حين طرح بعض العرب المشاركين في المؤتمر وبعده أن لليهود حقوقاً تاريخية في فلسطين، وقدموا فكرة "اتحاد الشعوب السامية بين العرب واليهود"، وهي الفكرة التي تطورت لاحقاً من خلال مفاوضات الحركة الصهيونية مع العديد من القوى العربية في سوريا والعراق ومصر، وذلك قبل قيام دولة إسرائيل، كما درس محمود محارب في عدة كتب وأبحاث، وكذلك وفق وثائق ومحاضر اللقاءات من قبل الصهيونية مع هذه القوى كما هي منشورة في مجلدات صدرت عن الجمعية الفلسطينية الأكاديمية لدراسة الشؤون الدولية (باسيا).
فلسطين وحالة التغييب المعرفي
عالجت الدراسات ما بعد الاستعمارية بفروعها المختلفة حالات الدول التي تخلصت من الاستعمار العسكري المباشر وحصلت على الاستقلال، بهذا المعنى فقد حللت هذه الدراسات الأثر الذي تركه الاستعمار بعد أن رحل، بما في ذلك استمرار احتلال الثقافة ومنهجيات وأدوات المعرفة. الموضوع مخالف في حالة فلسطين، حيث إن الاستعمار لم يرحل بعد ولكنه على العكس من ذلك، ما زال يتوطد ويتعزز، مستعملاً أدوات معرفية أيضاً من أجل تعزيزه، جوهرها هو شطب فلسطين من دائرة المعرفة المهيمنة، وهو تغييب بدأ منذ القرن الثامن عشر حين نشطت في فلسطين جمعيات إفنجليكانية توشحت بلبوس العلم، مثل صندوق اكتشاف فلسطين وغيره، حيث لم يكن لتلك الجمعيات من هم سوى اكتشاف المواقع المذكورة في التوراة فيها.
تعزز تغييب فلسطين رسمياً من خلال تصريح بلفور عام 1917، والذي حصر الحقوق الوطنية الجماعية فيها على اليهود. أما "باقي الطوائف غير اليهودية" كما تمت تسميتها في ذلك التصريح، فقد تم حصر حقوقها في حقوق فردية ودينية. ولم يتم تغيير هذا الحال حتى اتفاق أوسلو، الذي نص في ديباجته على "الحقوق السياسية المشروعة للشعب الفلسطيني"، ولكنه أبقاها في مستوى الإبهام، حيث لم يتم النص بوضوح على حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني. وجاء قانون الدولة القومية الإسرائيلي لعام 2018، ليعيد تأكيد ما ورد في تصريح بلفور: حقوق جماعية حصرية لـ"شعب إسرائيل" على "أرض إسرائيل"، فيما يكتفي بحقوق فردية ودينية لسواهم، وجاءت صفقة القرن الأمريكية في مطلع عام 2020 لتؤكد على ذات فحوى قانون الدولة القومية.
يعني ما تقدم أن الفلسطينيين كشعب، قد وضعوا خارج إطار حق تقرير المصير والحق في بناء حداثتهم. وقد جاء أوسلو ليضع الفلسطينيين في دائرة احتمالية الحصول على حق تقرير المصير، أو "في موقع الاحتمال الحداثي" (ناشف، 2010، ص120) مشترطاً الانتقال إليه بنجاح المفاوضات في تحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967. وبعد أوسلو، ظل الفلسطينيون يتأرجحون بين تحقق الحداثة إذا ما تم بناء نظامهم السياسي والقانوني والاقتصادي في حال التوصل إلى تسوية سياسية متفق عليها، وبين البقاء في وضع الاحتمال الحداثي، أو النزول عنه مجدداً إلى حالة الشطب التام من الحق في الحداثة كما كان عليه الحال مع تصريح بلفور، وما زالت حالة التأرجح هذه قائمة حتى اليوم. لا تعني هذه الخطط أنه تم قبولها من الشعب الفلسطيني؛ فقد بقي يقاومها فارضاً حداثته ومجتمعه المبني على المشاركة والتعددية والانتخابات (أبو لغد وآخرون، 1993)، وفيما لم ينتصر الشعب الفلسطيني حتى اليوم، إلا أنه في المقابل لم يهزم، مما يتيح المجال لتكرار المحاولات حتى النصر.
في عهد الانتداب البريطاني على فلسطين، غطي المشروع الصهيوني بترسانة من المقولات التي سعى لتجسيدها على الأرض، كمقولة العرق اليهودي المستمر في المنفى على مدى ألفي عام، ذي الحق في نفي المنفى المتسم بأزلية اللاسامية وكره اليهود عبر العودة إلى "أرض الميعاد" المسماة بـ "أرض إسرائيل"، من أجل إقامة مجتمع حداثي فيها بعد إخراج الغرباء الذين سيطروا عليها بعد نفي اليهود منها قبل ألفي عام، وإخضاع من يتبقى منهم لحكم اليهود بدون التساوي في الحقوق مع الآخرين. في هذا الإطار، روجت دعاية أن الحركة الصهيونية هي حركة تحرر وطني، وأنها تميزت بالأخلاقية، وبالتالي فقد بنت في المناطق الفارغة إلى جانب الفلسطينيين وليس على حسابهم، وأنها اختارت أسلوب شراء الأراضي وليس الاستحواذ القسري عليها. وبناء على "أخلاقيتها" المدعاة، فقد توجهت الصهيونية لكل يهود العالم مطالبة إياهم بأن يعتنقوا الصهيونية وترك الدول التي يعيشون فيها والهجرة إلى "أرض الميعاد"، من أجل الحصول على الملاذ الآمن وصنع الحداثة وصنع السلام القائم على الردع مع جيرانهم. وقد فكك الكاتب هذه الادعاءات علمياً في ورقة أخرى قدمت في مؤتمر "نقض الرواية الصهيونية" الذي عقد في رام الله في نهاية حزيران 2021، بترتيب من مفوضية حركة فتح بالتعاون مع جامعة القدس المفتوحة.
اتخذت الكولونياليتية التي قدم مفهومها كويخانو وفق أعلاه (Coloniality) بعد نشوء دولة إسرائيل عام 1948، شكل طرح الأسرلة على فلسطينيي الداخل، ولكن هذه الأسرلة لم تكن سوى مشروع مستحيل، فالصهيونية لم يكن في نيتها أن يتحول الفلسطينيون إلى إسرائيليين، فذاك الحق عندها مقصور على اليهود، فيما أرادت من أطروحة الأسرلة ما لا يتعدى تشويه الهوية الفلسطينية لفلسطينيي الداخل، وخلق أوهام إمكانية تحقيق المساواة مع اليهود بين ظهرانيهم، وتكوين أذناب للأحزاب الصهيونية. ومن الجانب الفلسطيني في الداخل لم تؤد الأسرلة إلى تأسرل، وذلك بفعل استمرار مصادرة الأراضي وهدم المنازل وعدم الاعتراف بالقرى العربية ومنع عودة المهجرين خارج قراهم ورفض عودة اللاجئين، هذا عدا قلة محدودة من الأعوان في أوائل سنوات عمر دولة إسرائيل الذين اكتسبوا اسم "العربي الجيد" (على غرار شخصية رشيد بك في رواية الأرض القديمة المتجددة: التنيولاند لهرتسل)، بسبب وهمهم أن الانخراط والتعاون مع الأحزاب الصهيونية هو السبيل الوحيد لتحقيق مطالب تحسين أوضاع باقي شعبهم في الداخل، وما زالت الأقلية المتوهمة بأنها استطاعت التأسرل موجودة حتى اليوم بين فلسطينيي الداخل.
بعد احتلال عام 1967 تلفعت الطروحات الكولونياليتية بأردية جديدة مثل "الاحتلال الخير"، صاحب الأفضال والجالب للمنافع من تنمية وتعليم عال، وتشغيل للعمال في إسرائيل. وبعد أوسلو ونشوء السلطة الوطنية الفلسطينية، انتشرت أطروحات وكأن الاحتلال قد انتهى، وأن النزاع قد سلك طريقه للحل، وأن مرحلة ما بعد نزاع (Post -Conflict) قد بدأت تتمثل المهمة الرئيسية فيها ببناء مؤسسات دولة فلسطين تمهيداً للاستقلال، ولحقتها في فترة تالية أفكار "السلام الاقتصادي" كما سميت. ساهمت أطروحات شمعون بيرس وحزب العمل حول الشرق أوسطية في الترويج لهذه الأطروحات، كما عززتها أطروحات الدول المانحة حول بناء مؤسسات الحكم الرشيد وتعزيز المهنية ودعم تطور نخب مهنية محايدة وغير مسيسة من خلال المنح المالية. ونشأ بناء على ذلك، حالة بدا منها أن حالة الكفاح من أجل التحرر الوطني يجب أن تتوقف لتحل محلها حالة البناء الوطني التي تم تكوين ترسانة نظرية كاملة لتسويغها سميت في أدبيات حل النزاع باسم "بناء السلام"، قصد بها بناء مؤسسات الدولة السياسية والقانونية والاقتصادية من أسفل، على طريق أن تصبح الدولة حقيقة واقعة بعد نجاح المفاوضات في الوصول إليها.
أفكار بحثية
تقترح هذه الورقة إطلاق مسار بحثي ينتهي بمؤتمر علمي يقوم على تحليل نقدي ابستمولوجي معمق لكل ما سبق ذكره، وتجلياته في حالة فلسطين التي ما زالت مسقطة من الخارطة الدولية منذ تصريح بلفور وحتى اليوم رغم كفاحات الشعب الفلسطيني الذي لم ينهزم. تتعلق الابستمولوجيا (نظرية المعرفة) ببحث السؤال: كيف نعرف ما نعرفه؟ أي ما هي الأطر المفاهيمية والفرضيات التي ننطلق منها من أجل معرفة ما نعرفه عن حالنا؟ وللإجابة على هذا السؤال، يمكن أن يتشكل فريق بحثي فلسطيني متعدد التخصصات في دراسة بعض الأسئلة المرتبطة، ومن ثم عقد مؤتمر علمي حولها، ومن هذه الأسئلة:
أولاً: في مجال الكولونياليتي:
ما هي الأطر النظرية الملائمة لدراسة إنتاج المعرفة في حالات البلدان التي تخلصت من الاستعمار، أو التي ما زالت ترزح تحته؟
كيف نفهم حالة فلسطين تحت ثلاثية الاستيطان الاستعماري والأبارتهايد والاحتلال العسكري؟
كيف نرى تطبيقات هذه الثلاثية على كافة تجمعات الشعب الفلسطيني سواء داخل إسرائيل، أو في الضفة والقطاع والقدس وفي دول اللجوء ودول الشتات في كافة أرجاء الأرض؟
كيف تطورت الهوية الوطنية الفلسطينية؟ وما هي علاقاتها بالهويات العربية والإسلامية والمتوسطية وغيرها؟
كيف نحلل الأدوات المعرفية التي استخدمها الاستعمار الاستيطاني الصهيوني أثناء تكون مشروعه الاستيطاني الاستعماري؟ وما هي آثارها في مراحل مختلفة قبل وبعد نشوء دولة إسرائيل، وبعد احتلال عام 1967؟
كيف نفهم سياسات الغرب والأطر المعرفية التي استخدمها من أجل تحقيق هيمنته على المنطقة؟ وكيف دعمت الحركات الإفنجيلية الصهيونية منذ ثمانينيات القرن التاسع عشر مروراً بتصريح بلفور وحتى اليوم؟ وما هي السياسات النيوليبرالية / الشرق أوسطية / والمتوسطية؟ وكيف انعكست هي ومفاهيمها على فلسطين مجتمعاً ونخباً؟
كيف نفهم استبطان نخب عربية وفلسطينية للرواية الصهيونية، و/أو اعتناقها المفاهيم الاستعمارية الغربية في دراسة ومشاريع بناء مجتمعها؟ وفي تطبيعها مع إسرائيل؟
ثانياً: في مجال التحرر من الاستعمار (De-Coloniality):
كيف نفهم حالة حركة التحرر الوطني الفلسطيني بالمقارنة مع حالات أخرى خضعت للاستيطان الاستعماري كالجزائر وجنوب أفريقيا وأيرلندا؟
كيف نرى العلاقة بين التحرر الوطني والبناء الوطني؟
كيف نرى وحدة الشعب الفلسطيني في المقاومة، وما هي الأطر المفاهيمية والمؤسساتية لتحقيق ذلك تحت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني؟
كيف ندرس النتاجات الأكاديمية الفلسطينية في إطار استبطانها أو انفكاكها عن المقولات الاستعمارية، والاستيطانية الاستعمارية؟ وكذلك عن "الإسرائيليات" في دراسة تاريخ فلسطين القديم؟
كيف عبرت الروايات والشعر والأدب والفن عن روح ومفاهيم وإرادة المقاومة، وكيف عكستها؟
كيف يمكن فهم المقاومة الفلسطينية الشاملة للشعب الفلسطيني بأسره، وأشكالها وأدواتها في إطار العولمة؟
أهمية المؤتمر
تكمن أهمية المؤتمر في بيان المفاهيم والإشكاليات المتعلقة بالتحرر الذاتي، في الحالة النضالية الفلسطينية على وجه الخصوص، وتنبثق من هذه الفكرة مجموعة من التساؤلات التي يثيرها المؤتمر ويضع التصورات المناسبة لها، وأبرز هذه التساؤلات: ما مفهوم التحرر الذاتي؟ كيف يمكن تجسيد التحرر الذاتي للفلسطينيين؟ ما الإشكالات التي يواجهها الفلسطينيون في طريق تحقيق التحرر الذاتي؟ كيف يكون إنتاج المعرفة مقاومة؟ ما أشكال المعرفة التي ينبغي أن يعمل الفلسطينيون على إنتاجها؟
يسعى المؤتمر إلى لفت انتباه جميع شرائح المجتمع إلى أهمية إنتاج المعرفة بجميع أنواعها، العلمية والأدبية والفنية، كي يسهم الجميع في وضع بصمة مهما كانت بسيطة، وتقع على عاتق العلماء والأكاديميين والسياسيين مهمة الدعم والإرشاد والتوجيه بكل السبل المتاحة.
أهداف المؤتمر
- مقاربة مفهوم التحرر الذاتي في الحالة الفلسطينية.
- بيان الطرق والوسائل والأساليب التي يمكن أن تحقق التحرر الذاتي للفلسطينيين.
- مناقشة الإشكالات التي يواجهها الفلسطينيون في طريق تحقيق التحرر الذاتي.
- مقاربة تحديد مفهوم إنتاج المعرفة المقاومة.
- مناقشة أشكال المعرفة التي تساهم في التحرر الذاتي للفلسطينيين.
محاور المؤتمر
- المحور الأول: التحرر الذاتي للفلسطينيين
- مفهوم التحرر الذاتي في الحالة الفلسطينية... إلى أين؟
- اتجاهات التحرر الذاتي العربية والعالمية.
- اتجاهات ونماذج التحرر الذاتي الفلسطينية.
- الحركة الوطنية الفلسطينية ومنجزات التحرر الذاتي.
- تجارب عالمية.
- نحو مقاربة تمازج بين التحرر الذاتي والأمن القومي – نموذج الدولة المحتلة.
- المحور الثاني: إنتاج المعرفة المقاومة
- مفهوم إنتاج المعرفة المقاومة.
- المقاومة وإنتاج المعرفة العلمية.
- المقاومة وإنتاج المعرفة الأدبية.
- المقاومة وإنتاج المعرفة الفنية.
- تجارب المقاومة الفلسطينية.
- المحور الثالث: المعرفة المقاومة ومقاطعة إسرائيل
- الصمود في مواجهة "اتفاقية إبراهيم".
- مقاطعة إسرائيل – نموذج ناجح للمقاومة على كافة المستويات.
- المقاطعة الأكاديمية... الفرص والإمكانات.
- دولة الأبارتهايد والاستيطان الاستعماري والاضطهاد – تحولات في البيئة المعرفية للمقاومة والمقاطعة.
- دولة الاحتلال بين انفكاك المجتمع الإسرائيلي وتراجع التأييد الأمريكي.
- المحور الرابع: الإنتاج المعرفي الجنوبي المقاوم.
- نموذج الصين.
- نماذج أفريقية.
- نماذج أمريكا اللاتينية.
- نماذج المغرب العربي.
- المحور الخامس: إنتاج المعرفة المقاومة في التعليم.
- في المناهج المدرسية.
- في الجامعات.
- المحور السادس: نظام الفصل العنصري والأبارتهايد
المشاركون
- أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والكليات والمعاهد الفلسطينية والعربية والعالمية.
- المؤسسات الوطنية المختلفة أصحاب العلاقة.
- الخبراء والاستشاريون والباحثون في مجال التحرر الوطني.
- الموظفون في وحدات التخطيط في المؤسسات الوطنية المختلفة.
- الحركات الوطنية الفلسطينية.
- واضعو السياسات وأصحاب القرارات، وغيرهم من ذوي العلاقة والمسؤولين.
- الباحثون والدارسون والمهتمون بقضايا التحرر الوطني.
شروط المشاركة
يتقدم المشارك ببحث ضمن محاور المؤتمر وفق الآتي:
- تقديم الملخصات بشكل منفصل في موعد لا يتجاوز 15/ 1/ 2022، ويجب ألا يتجاوز الصفحة الواحدة.
- يتم الرد على الملخصات بالقبول أو الرفض، أو التعديل بتاريخ 2022/1/30.
- تقديم الأوراق البحثية الكاملة التي قبلت ملخصاتها في موعد لا يتجاوز2022/6/1 على أن يتضمن البحث ملخصاً باللغتين العربية والإنجليزية، بحيث يكون مدققاً لغوياً. ويجب أن يتضمن البحث جميع العناصر العلمية، مثل: مشكلة البحث، وأهميته، وأهدافه، ومبرراته، وحدوده، والمنهجية، والإجراءات، والأدوات، وأهم النتائج والتوصيات، إلخ.
- يتم تحكيم الأبحاث المستلمة، وذلك حتى تاريخ 2022/7/15.
- منح الباحثين الذين قبلت أبحاثهم مدة أسبوعين من أجل إجراء التعديلات المطلوبة على أن يكون آخر يوم لتسليمها كاملة بتاريخ 2022/8/1.
- يعقد المؤتمر يوم الثلاثاء الموافق 2022/11/29 بالتزامن مع احياء اليوم العالمي مع التضامن الشعب الفسطيني.
- يكون المؤتمر وجاهياً للباحثين الموجودين في فلسطين، وعبر تقنية "زوم" للباحثين خارج الوطن.
- يجب أن يتضمن البحث جميع العناصر والأسس للبحث العلمي.
- لن تُقبل أي أبحاث سبق أن قدمت إلى مؤتمر آخر، أو نشرت سابقاً، أو مقدمة للنشر لدى أي جهة.
- يتم قبول المقالات العلمية النظرية التي تشمل الأفكار والمفاهيم الجديدة المتعلقة بموضوعات المؤتمر.
- إدراج قائمة المراجع في نهاية ورقة البحث؛ فإذا كان المرجع كتاباً، فيجب أن يتضمن الاستشهاد (التوثيق): اسم المؤلف، وعنوان الكتاب، واسم المترجم إن وجد، ومكان النشر، والناشر، والطباعة، وسنة النشر، ورقم الصفحة. أما إذا كان المرجع مجلة، فيجب أن يشير الاستشهاد إلى اسم المؤلف وعنوان البحث واسم المجلة وحجمها وتاريخ النشر ورقم الصفحة.
- عدد كلمات الورقة البحثية يجب أن يتراوح بين (5000 و7000) كلمة مطبوعة على الـ (Word) بخط (14) عادي للنص، وخط (14) غامق للعناوين، بمسافة (1.5)، وهوامش (2.5 سم) لجميع الجوانب.
- تقديم السيرة الذاتية للباحث مع ورقة البحث، مع تحديد التخصص العام، والتخصص الدقيق، والدرجة العلمية، والرتبة الأكاديمية، والجامعة التي تخرج فيها، ومكان العمل (الجامعة أو المؤسسة).
- إدارة المؤتمر ليست ملزمة بتقديم أسباب ومبررات للأبحاث التي ترفضها اللجنة العلمية.
- ملء استبانة المشاركة وتقديمها.
- يمنح المشاركون بأوراق علمية شهادات تقديرية.
مكان انعقاد المؤتمر
يعقد المؤتمر عبر تقنية "زووم" من خلال الرابط الاتي: https://us02web.zoom.us/j/89890380964
من أجل المواءمة ما بين اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني والنكبة، قررت اللجان انعقاد المؤتمر على جلستين: الأولى افتتاحية بتاريخ 2021/11/29 تزامناً مع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والأخرى بتاريخ 2022/11/29 تزامناً مع ذكرى النكبة الأليمة.
لجان المؤتمر
اللجنة العليا للمؤتمر:
- الأمين العام للمؤتمر ومشرفه الأستاذ الدكتور سمير النجدي رئيس جامعة القدس المفتوحة.
- السيد مؤيد شعبان، وزير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.
- الدكتور احمد أبو هولي، رئيس دائرة شؤون اللاجئين.
- الاستاذ عيسى قراقع، رئيس المكتبة الوطنية
- الدكتور نبيل أبو ردينة، وزير الإعلام
- الدكتور رمزي عودة الأمين العام للحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال الإسرائيلي والأبارتهايد، رئيس اللجنة التحضيرية
- الأستاذ الدكتور عبدالرؤوف خريوش، رئيس اللجنة العلمية، جامعة القدس المفتوحة.
- اللواء حابس شروف، نائب مدير معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي.
- السيد ناصر أبو بكر، نقيب الصحافيين.
- الأستاذ الدكتور محمد الطيطي ،مساعد رئيس جامعة القدس المفتوحة.
- الدكتور وليد سالم، أستاذ العلاقات الدولية المساعد في جامعة القدس، ومدير تحرير مجلة “المقدسية”، نائب رئيس اللجنة العلمية.
- الدكتورة صباح الشرشير، عضو الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال الإسرائيلي والأبارتهايد.
- الأستاذ عوض مسحل، مدير دائرة العلاقات العامة والدولية والإعلام، نائب رئيس اللجنة التحضيرية.
اللجنة التحضيرية:
|
المنصب |
المسمى الوظيفي |
الاسم |
الرقم |
|
رئيس اللجنة |
الأمين العام للحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال الإسرائيلي والأبارتهايد |
د. رمزي عودة |
1. |
|
عضو |
وكيل وزارة الاعلام |
د. يوسف المحمود |
2. |
|
نائب رئيس اللجنة |
مدير دائرة العلاقات العامة والدولية والإعلام/ جامعة القدس المفتوحة |
أ. عوض مسحل |
3. |
|
عضو |
نائب رئيس الجامعة لشؤون قطاع غزة/ جامعة القدس المفتوحة |
د. رأفت جودة |
4. |
|
رئيس اللجنة العلمية |
رئيس اللجنة العلمية/ جامعة القدس المفتوحة |
أ. د. عبد الرؤوف خريوش |
5. |
|
عضو |
بروفيسور في الاقتصاد وعميد كلية التجارة والاقتصاد كليات ايوا الشرقية (الولايات المتحدة الأمريكية) |
أ. د. جون ضبيط |
6. |
|
عضو |
نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية / جامعة القدس المفتوحة |
أ. د. حسني عوض |
7. |
|
عضو |
مساعد نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية / جامعة القدس المفتوحة |
أ. د. مجدي الزامل |
8. |
|
عضو |
باحثة في شؤون المنظمات الدولية / جامعة 6 أكتوبر (مصر) |
د. مي غيث |
9. |
|
عضو |
محاضر جامعي |
د. صالح أبو عمرة |
10. |
|
عضو |
باحثة في الشؤون السياسية والقانونية والبرلمانية والشأن الفلسطيني والدولي، محاضر جامعي (الأردن) |
د. دانييلا القرعان |
11. |
|
عضو |
ووكيل مساعد وزارة الشؤون الاجتماعية وعضو الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال الإسرائيلي والأبارتهايد. |
د. صباح الشرشير |
12. |
|
عضو |
محاضرة غير متفرغه/ جامعة القدس المفتوحة |
د. حكمت المصري |
13. |
|
عضو |
دكتوراه علم نفس، وباحث واستشاري في قضايا العنف |
د. إياد الكرنز |
14. |
|
عضو |
أستاذ العلوم السياسية/ جامعة فلسطين |
د. علاء حمودة |
15. |
|
عضو |
باحث أكاديمي |
د. زياد مدوخ |
16. |
|
عضو |
باحث أكاديمي |
د. رانيا اللوح |
17. |
|
عضو |
باحث أكاديمي |
د. وجيه أبو ظريفة |
18. |
|
عضو |
باحث في شؤون الجماعات الإسلامية |
أ. أنور رجب |
19. |
|
عضو |
مساعد عميد كلية الآداب/ جامعة القدس المفتوحة |
أ. بسيم أيوب |
20. |
|
عضو |
جمعية جذور للتنمية والثقافة |
أ. بشار رواجبة |
21. |
|
عضو |
باحث أكاديمي |
أ. الياس زنانيري |
22. |
|
عضو |
رئيس هيئة الموروث الثقافي - لفتا |
أ. يعقوب عودة |
23. |
اللجنة العلمية
|
المنصب |
المسمى الوظيفي |
الاسم |
الرقم |
|
رئيس اللجنة العلمية |
رئيس اللجنة العلمية/ جامعة القدس المفتوحة |
أ. د. عبد الرؤوف خريوش |
1. |
|
عضو |
معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي |
اللواء حابس شروف |
2. |
|
نائب رئيس اللجنة |
مدير تحرير مجلة "المقدسية" |
د. وليد سالم |
3. |
|
رئيس اللجنة التحضيرية |
الأمين العام للحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال الإسرائيلي والأبارتهايد |
د. رمزي عودة |
4. |
|
عضو |
أستاذ علوم سياسية/ جامعة بورسعيد (مصر) |
أ. د. جمال زهران |
5. |
|
عضو |
عضو هيئة تدريس/ جامعة القدس المفتوحة |
أ. د. عمر عتيق |
6. |
|
عضو |
أستاذ العلوم السياسية. كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية/جامعة الجزائر (الجزائر) |
أ. د. مسعود شعنان |
7. |
|
عضو |
مدير فرع دورا / جامعة القدس المفتوحة |
أ. د. نعمان عمرو |
8. |
|
عضو |
أستاذ مساعد في العلوم السياسية والقانون/ دائرة العمل والتخطيط الفلسطيني |
د. إبراهيم المصري |
9. |
|
عضو |
أستاذ جامعي/ جامعة ابن زهر (المغرب) |
د. الحسين الرامي |
10. |
|
عضو |
أستاذ الفلسفة/ جامعة الاستقلال |
د. رياض شريم |
11. |
|
عضو |
أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية/ الجامعة العربية الأمريكية |
د. سنية الحسيني |
12. |
|
عضو |
مدير فرع يطا / جامعة القدس المفتوحة |
د. محمد الحروب |
13. |
|
عضو |
حقوفي ومفكر عربي (العراق) |
د. عبد الحسين شعبان |
14. |
|
عضو |
أستاذ جامعي قانون دولي/جامعة قرطاج (تونس) |
أ.د. هاجر قلديش |
15. |
|
عضو |
أستاذ علاقات دولية (بريطانيا) |
د. فادي أبو سيدو |
16. |
|
عضو |
مدير فرع غزة / جامعة القدس المفتوحة |
د. نادر حلس |
17. |
|
عضو |
أستاذ قانون دولي/ (سفير دولة فلسطين في السنغال) |
د. صفوت ابراغيث |
18. |
|
عضو |
رئيس قسم اللغة العربية / جامعة القدس المفتوحة |
د. زاهر حنني |
19. |
|
عضو |
عضو هيئة تدريس / جامعة بيرزيت |
د. موسى سرور |
20. |
|
عضو |
وزارة السياحة والآثار |
د. ضرغام فارس |
21. |
|
عضو |
عضو هيئة تدريس/ جامعة القدس المفتوحة |
د. هشام دويكات |
22. |
|
عضو |
أستاذ الفلسفة في العلوم التقنية / جامعة الاستقلال |
د. حازم الحروب |
23. |
|
عضو |
أستاذة الفكر السياسي وتاريخ الحركة الصهيونية / وزارة العدل |
د. إلهام الشمالي |
24. |
|
عضو |
مساعد عميد كلية الحقوق لشؤون البحث العلمي / جامعة الأزهر |
د. محمد أبو مطر |
25. |
|
عضو |
أستاذ مساعد في جامعة القدس |
د. شاهر العالول |
26. |
|
عضو |
عضو مجلس أمناء جامعة غزة |
د. سائد الغول |
27. |
|
عضو |
معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي |
د. عبد الرحيم الشوبكي |
28. |
|
عضو |
أكاديمي، ومدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" |
د. عمر رحال |
29. |
|
عضو |
أستاذ مشارك في جامعتا القدس والعربية الأمريكية |
د. عبد الرحمن التميمي |
30. |
|
عضو |
أستاذ علوم سياسية معهد التخطيط القومي (مصر) |
د. هبة جمال الدين |
31. |
|
عضو |
معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي |
د. أحمد نزال |
32. |
لجنة العلاقات العامة والإعلام
|
المسمى الوظيفي |
المنصب |
الاسم |
الرقم |
|
قابة الصحفيين |
عضو |
أ. عبد الكريم عرقوب |
1. |
|
مدير مركز الإنتاج الفني/ جامعة القدس المفتوحة |
عضو |
أ. مهند منصور |
2. |
|
وزارة الإعلام |
عضو |
أ. بهاء العواودة |
3. |
|
علاقات عامة واعلام /جامعة القدس المفتوحة |
عضو |
أ. نيفين صلاح |
4. |
|
عضو |
الحملة الأكاديمية الدولية لمقاومة الاستيطان والاحتلال والأبرتهايد |
أ. هيام صبيح |
5. |
|
عضو |
الحملة الأكاديمية الدولية لمقاومة الاستيطان والاحتلال والأبرتهايد |
أ. أحمد أبو لبن |
6. |
|
علاقات عامة واعلام /جامعة القدس المفتوحة |
عضو |
أ. رائد دحلان |
7. |
اللجنة الفنية
|
المنصب |
المسمى الوظيفي |
الاسم |
الرقم |
|
عضو |
رئيس شعبة الدعم الفني/ جامعة القدس المفتوحة |
أ. وسيم نظيف |
2. |
|
عضو |
مركز الإنتاج الفني/ جامعة القدس المفتوحة |
أ. إبراهيم أبو تركي |
3. |
نموذج المشاركة
نموذج الترشيح لشهادة التكريم الوطنية
المراسلات
توجه جميع المراسلات والاستفسارات والمشاركات الخاصة بالمؤتمر إلى رئيس اللجنة العلمية:
أ.د. عبد الرؤوف خريوش
رئيس اللجنة العلمية
كلية الآداب / قسم اللغة العربية وآدابها
البريد الإلكتروني: [email protected]
تلفون: 00970599201375
الموقع الإلكتروني للمؤتمر: https://www.qou.edu/ar/viewEventDetails.do?eventId=842
بروشور المؤتمر
شهادة التكريم الوطنية للدبلوماسية الأكاديمية المناصرة للحقوق الفلسطينية
- الرئيسة
- المقدمة
- المدخل المفاهيمي
- الإطار النظري
- فلسطين وحالة التغييب المعرفي
- أفكار بحثية
- أهمية المؤتمر
- أهداف المؤتمر
- محاور المؤتمر
- المشاركون
- شروط المشاركة
- مكان انعقاد المؤتمر
- لجان المؤتمر
- نموذج المشاركة
- نموذج الترشيح لشهادة التكريم الوطنية
- المراسلات
- بروشور المؤتمر
- شهادة التكريم الوطنية للدبلوماسية الأكاديمية المناصرة للحقوق الفلسطينية